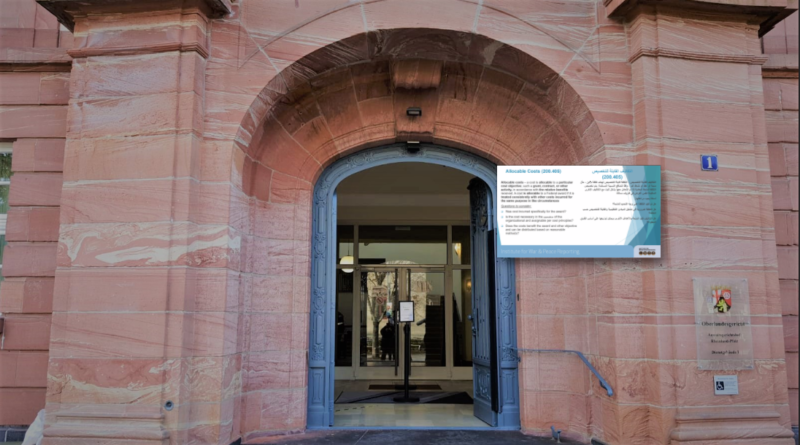المرافعة الختامية للمدعي والشاهد فراس فياض
لونا وطفة
“أنت أيها الداخل إلى هنا عليك التخلي عن كل الآمال. الكوميديا الإلهية، دانتي.
من غير الممكن أبداً ولأي سبب على وجه الأرض أن يتمنى أحدنا زيادة أو تحمل عواقب الألم، في لحظة الألم يمكن أن تتمنى شيئًا واحدًا فقط، هو أن يتوقف. “لا شيء أسوأ من الألم الجسدي في هذا العالم وفي مواجهة هذا الألم وعواقبه لا يوجد أبطال “، ١٩٨٤ جورج أورويل.
الداخل إلى هذا المكان مفقود والخارج منه مولود، إنها مقولة انتجتها مؤسسات المخابرات السورية ورددها المجتمع في السر والعلن وتحولت إلى كابوس طويل لم ينتهي بعد.
هذا تحديداً ماعلينا التعايش معه في لحظة الدخول إليها حتى نستطيع التعامل مع أجسادنا داخل تلك الأماكن المصممة لتدميرها.
حضرات القضاة المحترمين، المدعون العامون الأفاضل، السيدات والسادة المحامين الأفاضل،
أخبرني معالجي النفسي الدكتور كـ.هـ الذي عمل لفترة طويلة مع ناجيين من الهولوكوست عن أثر ومعنى الذكريات المؤلمة ” the Traumatic memories” من خلال هذه القصة التي أصبحت تعني الكثير لي عن قيمة التحدث:
أثناء اقتراب قوات الحلفاء من برلين قامت قوات الـ ss gards بإجبار الناجين في أحد معسكرات الاحتجاز للسير “بأجسادهم الهزيلة” بهدف نقلهم إلى مكان اخر، العديد منهم مات أو أعدم لعدم قدرته على استكمال المسير، في النهاية وصلوا إلى أحد الغابات بين براندبرغ وبرلين، وتُرِكوا بضعفهم في أجواء قاسية البرودة بهذا العراء، بعد فترة اضطر الناجون لأكل أجزاء من جذوع الأشجار للنجاة، ولكنهم لم ينسوا أن يحفروا ذكرياتهم على جذوعها، استمرت تلك الأشجار بالنمو صامدة وحمت آثار أجساد الناجين المحفورة على جذوعها حتى الآن، وستبقى مادامت هذه الأشجار باقية.
وأنا هنا أقف بين أيديكم أعيش معضلة وجودية بأنني نجوت، فأسأل نفسي لماذا نحن تحديداً نجونا؟ ما الذي حصل ويحصل لزملائنا الذين تركناهم خلفنا؟ ما الذي يمكننا فعله لإنقاذهم؟
أعلم أننا عاجزون حقاً عن فعل الكثير سوى الاستمرار في إخبار ما اختبرناه وعدم الصمت عنه مهما كانت التكلفة، هناك في أفرع المخابرات التي تمتلك طرقاً لا حصر لها بأذيتنا، هناك أكثر من مائة وتسعة وأربعين واثنان وستون ألف شخص ينتظرهم أحبائهم ممن اختطفوا أو تم الإيقاع بهم عبر مكائد يشتهر بها فرع الخطيب والأفرع المخابراتية السورية
الأخرى كعاقبة على مشاركتهم في الحراك الديموقراطي، أو كعاقبة لممارسة حقهم في التعبير. ومن ثم تبدأ مرحلة إنكار وجودهم، وهكذا تُطمس حقيقة وجود إنسان، ثم مجموعة بشرية ثم مجتمع، هكذا تُطمس ذات المجتمع وهويته؛ وهكذا يعيش مجتمع كاملٌ بحثاً عن ذاته المفقودة بفقدان معرفة مصير أحبائهم وفقدان العدالة لهم.
المثير للرعب هو أن جريمة الاختفاء القسري والتعذيب كانت أداة جوهرية لاستعراض القوة المطلقة التي لا رادع لها، التي استخدمتها الفروع المخابراتية في سوريا كجوهر لوجودها، التي تتبجح به أمام العالم وتبث الرعب والإرهاب لتتحكم بحياتنا يومياً حتى بعد نجاتنا.
كنت واحداً ممن اختفوا قسرياً باعتقالين اثنين؛ في اعتقالي الأول اختطفت من مقهى انترنت فجأة دون ان أكمل كلماتي الأخيرة مع حبيبتي وأصدقائي أثناء محادثتنا على الفيس بوك حول حقوقنا الأساسية في الديموقراطية والحرية مع انطلاقة المظاهرات في سوريا.
وفي الثاني اختطفت من مطار دمشق لأنني قررت أن أحمل كاميرتي وأنزل للشارع مصراً أن أوثق وأروي ما يجري، وعندما كُشف أمري قررت الهرب ظناً مني أنني أستطيع تهريب وإنقاذ ما وثقته.. للأسف الشديد لم تنجو الوثائق! لكن جسدي نجا ونجت معه الحكاية!.
تخيلوا أنكم تودعون أحد أفراد عائلتكم، والقسم الآخر من العائلة ينتظره على الطرف الآخر من المطار، وفجأة يختفي هكذا، لا تعرفون إن سافر أو بقي أو قرر الابتعاد عن هذا العالم، سيخيم عليكم كعائلة ظلال أسئلة متى وأين، وماذا؟ سيخنقكم الفقد والانتظار والبحث عنهم.
هكذا يستخدم النظام الوقت والانتظار للاستمرار في تعذيبنا واحتجاز تقدمنا حتى ونحن خارج سجونه، حتى في أماكن لجوؤنا؛ يقول صامويل بيكيت في مسرحية انتظار غودو:
“دعنا نذهب!
لا نستطيع.
لماذا لا؟
نحن ننتظر!.”
هذا ما عاشته عائلتي لشهور وما زالت تعيشه عوائل الكثير من المختفين قسرياً، المعضلة أن الاختطاف والاختفاء القسري والتعذيب مازال مستمراً في سوريا وأعلم بشكل لا شك فيه وفي كل لحظة نقضيها هنا، أن هناك فرد أو أكثر من عائلة سورية الآن يُجَرُّ ليلاقي نفس مصيري ومصير الذين شهدوا هنا، وأجزم أن وسائل التعذيب ازدادت وتطورت على مر هذه السنوات التسع، هناك الآن من يتعذبون، معلقين بين الحياة والموت، والجناة مازالوا في أماكنهم. إنه لشعور مؤذٍ يضربنا يومياً في قلب المعدة، شعور فظيع يمزق القلب!
أثر الاختفاء القسري يخلف صدمة شديدة علينا كمجتمع وعلينا كضحايا وحتى بعد النجاة أو الكشف عن مصير الذين قتلوا تحت التعذيب.
الآن وأنا أقف أمامكم هنا في مثل هذه الأوقات شديدة البرودة هنا في ألمانيا، وكأني هناك في دمشق، وتحديداً تحت الأرض حيث تزداد حدَّة البرودة في مركز الاحتجاز الوحشي شديد الرطوبة والمثقل بروائحنا المتعفنة في فرع الخطيب.
شبه عارٍ، مسلوب القدرة الجسدية و محطمٌ نفسياً، أشبه بجثة، بجسد نحيل جائع وعطش نتيجة الحرمان من الطعام والماء، ارتجف من البرد، بالكاد أستطيع التنفس أو إدراك العالم من حولي، سُلِبت مني حرية الرؤية و حجب عني إحساسي بالوقت قسراً، فقدت القدرة، ومعي مئات المعتقلين، على معرفة الزمن داخل المنفردات والزنزانات الجماعية المكتظة ببشر يستحقون الحياة الكريمة، أو المطروحون في الممرات، تسترنا بقايا ثياب ممزقة نتيجة التعذيب الوحشي، لا تعرف عوائلنا عنَّا شيئاً، كأننا في ثقب أسود أو في عالم موازٍ!!.
هناك في دمشق على طول الليل والنهار لم تتوقف أصوات الزعيق والصراخ الذي يزيد من حدَّة الرعب والتهديد ويزيد من ألم عجزنا عن مساعدة أنفسنا ومساعدة الذين يعانون.
كان الضجيج والصدى المركب لصرير فتح وإغلاق أبواب الزنازين المرعب الذي يفتح احتمالات إرهاب التعذيب أو القتل تحت التعذيب، أصوات ارتطام الكابلات بالأجساد، الصراخ الذي يصدر من أعماق الأجساد المعذبة، تهديد يومي لوجودنا، لذلك في ذلك الوقت راودتني رغبات لا حصر لها بالانتحار قبل أن تلتقط أذني صوت اقتراب جلادِي فرع الخطيب، وقبل أن يفتحوا باب زنزانتي، لسوقي لجلسة تحقيق و تعذيب.
يقول شوبنهاور: “إذا كنا نعاني من آلام جسدية شديدة ، أو إذا استمر الألم لفترة طويلة؛ كل ما نفكر فيه هو فقط إيجاد طريقة لإيقاف هذا الشعور بأي شكل، وهذا الذي يجعل الانتحار أمرًا سهلاً”.
في مثل هذه الأيام من هذا الشهر أثناء التحقيق سُئلت إذا كنت أحب “السيد الرئيس بشار الأسد” مع معرفتي مهما كانت الإجابة سيتم تعذيبي، انهال عليَّ الجلَّادون بالضرب بشكل عشوائي، بأيديهم وأقدامهم والكابلات والعصي وعُلِّقتُ من معصميَّ بحيث شعرت بتمزق وخدر لازال يرافقني حتى الآن في أغلب الأحيان، ولازلت أشعر به بشدَّة قبل النوم.
أيها السيدات والسادة كنت عاجزاً عن مساعدة نفسي! بالكاد أستطيع أن ألتقط أنفاسي من الضربات المنهالة على جسدي!! أثناء ضربهم لي أدخلوا شيئاً قاسياً في مؤخرتي، في تلك اللحظة شعرت بأنني تمزقت! وشعرت بألمٍ شديدٍ أسفل المعدة، شعرت أن رأسي قُسم نصفين من الداخل، ولا أعلم إن كان لصراخي صوت أو كتمه شعور الاختناق بالحلقوم أو شعور الإقياء الذي أوقفه عدم وجود أي طعام في المعدة والعجز، لقد سرت قشعريرة مصحوبة بتعرق وخدرغريب مفزع، فقدت على أثره الشعور بجسدي.
حتى الآن عندما أرى عصا بيد أحدٍ ما أشعر بخليط من الألم في المعدة و قلق شديد يرافقه ضيق بالتنفس وصعوبة في البلع مع إحساس بالسخونة وتعرق و قشعريرة تجري في كل جسدي.
بعد خروجي من السجن عانيت من التهابات شديدة، كنت خائفاً من التعامل مع الموضوع، كنت أشعر بالعار والذل والإهانة وقلة الحيلة، كنت أشعر بأن هناك شيء ما دُمِّر بشدة داخلي، ذلك الشيء المدمَّر زرع داخلي شعوراً غريباً بعدم الأمان وانعدام الثقة، هذا كله جعلني أكره جسدي وانتمائي لكل شيء!! راودتني مرات عديدة رغبات انتحارية بعد خروجي، حتى في أيام الصيف الأشد حرارة كان يتسلل إليَّ شعورٌ بالبرد يعيدني إلى ذلك المكان المظلم المليء بالرعب الذي سُلبت فيه حريتي وأصبحت غير قادر على استيعاب وقبول بأني أعيش بأمان في ألمانيا أو أحياناً في الولايات المتحدة حيث أعمل! للحظات يختفي شعوري بالأمان بالجغرافيا والمكان، ولا أصدق أنني هنا وأن هذا الواقع الآمن مجرد وهم أو أنه مؤقت وسيختفي، أحيانا أسمع صفيراً في أذنيَّ و أفقد الشعور بالمكان والزمان واكتشف أنني في وسط الشارع والإشارة الضوئية حمراء، أو أقف لوقت من الزمن دون أن أشعر بأن الوقت انقضى والإشارة تبدلت عدد من المرات.
هذه المشاعر كانت أسوأ منذ قدومي إلى ألمانيا، ولكن بعد اتباعي لعلاج نفسي أصبحت الأمور تتحسن شيئًا فشيئًا، لكنها أخذت الكثير من قدراتي التي كان من المفترض أن أضعها في الفن وصناعة الأفلام، أو في حياتي الاجتماعية.
قال لي معالجي النفسي أنها ستبقى معي طوال حياتي ولكن على الأقل سيكون هناك طريق ما للتعامل معها بشكل أكثر سلاماً.
العالم لا يؤمن بما مررنا به!! لأن صدمتنا وتجربتنا مروعة لدرجة يصعب عليهم سماعها أو قبولها أو الاعتراف بها، لأننا من المفترض أن نتطابق مع تصورات المجتمع فإن حصل شيء كهذا فعلينا الصمت لأننا الرجال الحماة!!.
مجرد التحدث حول هذا الأمر هو ضعف أو فعل قذر يسقط من قيمتنا و يقلل من احترامنا ويفقدنا الأهلية لنكون بشراً طبيعين.
معالجي النفسي يُرجِع عدم قبول أو إنكار المجتمع لتجربتنا هو أننا نشكل صورة لضعفه وعجزه عن فعل شيء تجاه تلك المأساة التي يفضل أن ينفي وجودها، ليظهر كمجتمع قوي وفخور بذاته غير مكسور بوجود ضحاياه.
في أحد تلك الأيام الباردة المشابهة لهذه الأيام بعد إحدى جلسات التحقيق التي قيل لي فيها: بأن أحداً لن يسمع بي مرة أخرى وبأن لديه كل الصلاحيات لفعل مايشاء ولذا علي إخباره بكل ما أعرف، كانت تحيط بي أصوات الضرب والشتائم المهينة والتهديدات بالقتل والقهقهة والتبجح والتفاخر وصوت نحيب زملائي المعتقلين، الهدف من ذلك هو إجباري على الاعتراف قسراً على أنني أصنع أفلامي كعمل تجسسي لأمريكا وفرنسا!.
مجرد تخيل هذه التهمة كانت كفيلة أن تحيطني برعب التفكير بأنني سأُعدَم وأُعلَّق بساحة المرجة كفرجة و نموذج تأديبي للمجتمع أو ربما الاختفاء للأبد! هكذا كانت تأكلني يومياً الأفكار في منفردتي!.
أنور ذاته قال في بيانه، الذي اعترف فيه بوجودي هناك، أنه اطَّلع على ملفي وأرجع سبب اعتقالي بأني على علاقة مع “الخارج”، أنور رسلان تشرَّب معتقدات النظام بأن ما قمت به هو جريمة استحق عليها العقاب، تلقي تمويل لشرائطي السينمائية من الغرب جريمة وإنجاز شرائطي السينمائية جريمة!.
كل ذلك عقاب لي، كصانع أفلام وثائقية، لأنني تجرأت في أن أروي تلك الحكاية، بل أكثر، لأن الحكاية احتوت مشاهد تنتقد النظام السوري بشكل صريح، هناك مشهدٌ واضحٌ يرصد إطلاق أعيرة نارية حيَّة من قبل قوات النظام السوري على المتظاهرين السلميين وآخر يرصد سقوط صورة الديكتاتور بشار الاسد وتحطمها. قيل لي همساً من قبل زميل مجاور لي في الزنزانة وقتها بأن ذنبي كبير وأنني سأُعدَم وعلي الصلاة، لكن بالنسبة لي نشأت ملحداً ورافضاً لوجود إله، مؤمناً فقط بالديموقراطية والحق بالحرية وحرية الضمير.
لم أجد طريقاً للإيمان والصلاة لهذا الله الذي يشاهد التعذيب ويصمت عنه أو يشارك به ويتمتع بوقوعه علينا كما يتمتع به الجلادون ورؤسائهم، الله غير موجود هناك أو كما يقول نيتشه: “الله ميِّت ولا يزال ميتاً”.
الحقيقة أن لدينا حياة واحدة وأجهزة التعذيب سلبتها منا ونحن هنا في هذا المكان استعدنا قدراتنا على التحدث لأننا نبحث عن العدالة بكل الوسائل ليس فقط لنحاول تجاوز ما مررنا به بل أكثر، لنستكمل هذه الحياة الواحدة.
أيها السيدات والسادة الأفاضل:
بعد أن شاركت تجربتي أمام هيئتكم الموقرة تعرضت لحملة تشهير وكراهية مروعة، حيث خرجت دعوات من أنصار أنور رسلان واياد الغريب، مندوب أحدهم يجلس هنا خلفي في هذه المقاعد، نشروا شهادة مزورة لي على صفحات تلك المؤسسة وادَّعى من نشرها على أنها شهادتي حرفاً بحرف مع الإفصاح عن اسمي ومعلوماتي الشخصية بشكل صريح،
منتهكاً حقوقي الشخصية التي أقرتها محكمتكم الموقرة لي، ثم، وبدفع منه، استخدمت الأخيرة لتحريض الناس على كراهيتي والضغط عليَّ لسحب شهادتي، ولكن أيضاً للدعوة لقتلي أو حجب حقي في المطالبة بالعدالة.
لقد أُرسِل المتصيدون للاتصال بي أو بالمحامي أنور البني وزملائي في العمل وعائلتي لتَصَيُّد تسجيلات لمكالمات صوتية لنا، أو رسائل أو منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي للزيادة من حدة خطاب الكراهية.
لم يتوقف الأمر هنا، بل استخدموا منصات مدعومة من قطر وتركيا لنشر معلومات كاذبة و مضللة عني.
نتيجة لذلك تلقَّت عائلتي تهديدات بالقتل والتصفية، وأُرسِل مندوبون مرتبطون بشكل أو بآخر بعلاقاتٍ، لجمع معلومات عني لاستخدامها للتشهير والإساءة لي ولعائلتي، مما اضطرني بشكل دوري لتغيير مكان سكن عائلتي خوفاً عليهم من الانتقام على الرغم من التكلفة وصعوبة إيجاد سكن لهم.
هناك صفحة على الفيس بوك يديرها أقرباء أنور رسلان تسمى “محاكمة العقيد أنور رسلان في ألمانيا” “صفحة مختصة بإنصاف العقيد أنور رسلان ابن تلدو المحترم” بدأت منها إطلاق تلك الدعوات ومازالت الصفحة هناك ويمكنكم الاطلاع عليها.
حاولت هذه الدعوات تحويلي لنموذج لترهيب الشهود والضحايا لردعهم عن رواية تجاربهم أو ترهيبهم أو التشويش عليهم أو تقويض ثقتهم بذاكرتهم ونزع أي إيمان وثقة من جدوى هذه المحاكمة ومن جدوى الإدلاء بشهاداتهم، محاولين تحويل الضحايا الى جناة والجناة الى ضحايا.
لقد ترك ذلك أثراً كبيراً على أمان عائلتي وأماني، وتسبب بأضرار حقيقية على مهنتي وكلفني جهداً نفسياً ومالياً لمواجهتها.
على الرغم من كل ذلك، أنا هنا مرة أخرى! أشعر بالرغبة أكثر للاستمرار في النضال والتحدث عن تجربتي دون توقف، لأن تكلفة الصمت أكثر وطأة بأثرها على ذواتنا من التحدث.
قال لي معالجي النفسي أن الاعتراف بالضرر الشديد الذي تعرضت له لا يمنح الجناة انتصاراً معنوياً بل الصمت عن الضرر هو ما يزيد من من قوة الجناة واستمرارهم في انتهكاتهم وتحقيقهم انتصاراً معنوياً بخضوعنا للإسكات.
الدعوات ذاتها طلبت الغفران لأنور رسلان وإياد الغريب وحولتهم لضحايا وانتقدت محاكمتهم على أنها خطأ لأنهما منشقان أو لأنهما من المسلمين السُنَّة أو لأنهما ينتميان لمناطق عشائرية ومناطق اسُتهدفت من قبل نظام بشار الأسد أو لأنهما أو لأنهما، لكنهما كانا الجزئية التي شكلت جسد نظام التعذيب التي كان يتحرك بها من خلال عملهم المتفاني لأجله ولأجلهما.
لم تحركني تلك الدعوات وتحديداً العدائية و التشهيرية التي أُطلِقت ضدنا كضحايا بل زادتني إصراراً أن أنور رسلان لم يمثل نفسه! بل هو تعبير مباشر عن كل معتقدات نظام التعذيب الذي تطور واستمر لعقود، إنه يمثل جسد السلطة وعقلها وتفكيرها المتلاعب والمنفذ.
على مدى عقود السلطة، تكتب السلطة وتحاول إنكار ونفي تجربتنا وتبرير وتجميل ما يحصل وتبحث عن أي طريقة للتأثير على حياتنا وحياة عوائلنا و محيطنا الاجتماعي لإرهابنا ومنعنا من التحدث أو لتقويض التجارب؛ وعلى امتداد جلسات المحاكمة يكتب أنور ويفنِّد ويحاول تقويض التجارب الفردية، وبتقويض التجارب الفردية يتم تقويض تجارب المجتمع بأكمله.
النظام ليس فقط جسد يعذب ويبيد أو جسد يأمر بالتعذيب، النظام أيضاً مُفكر شريرٌ ومتلاعبٌ متمرس خطير، يعتقد دائماً أنه من الممكن الاستفادة منه لأنه تجسيد كامل للخبرة والموهبة بممارسة الأفعال البدائية العنيفة، هذه الخبرة والموهبة بالذات هي من شوَّهت أجسادنا؛ هي التثقيف الذي تحدث عنه أنور رسلان في بيان دفاعه، وبسببها نحن لاجئون هنا نبحث عن الأمان وإعادة الاعتبار لأجسادنا.
فرع ٢٥١ مكان لتثقيفك مُجبراً بعنف لا حدود له على حب نظام بشار الأسد و باختبار أكثر الأساليب شراً على أجسادنا واختبار احتمالات الموت المتعددة، وإن خرجنا أحياء ستبقى آثار تلك التجربة المدمرة محفورة عميقاً في كل حواسنا، ولنرى إلى متى يمكننا البقاء على قيد الحياة مقاومين آثار تلك التجربة.
أنا لم أنجو و لم أتعافى منها كلياً، حتى الآن أنا مازلت أحاول وأقاوم.
لم يكن يهمني كثيرًا آلية انتقام النظام وأساليب متصيدي الضحايا منهم أو أي وصمة عار سيبذلون جهودهم لإلصاقها بي، لكنني أعرف أنني كنت وقتها طالباً بريئاً متنقلاً بين عدد من الدراسات وصانع أفلام في بداية مشواري ولدي حلم، ذلك الحين كنت أبحث عن مستقبلي هرباً من التجنيد في جيش النظام؛ هرباً كي لا أكون جزءاً منه أو صورةً عنه حتى ولو ليوم واحد! والآن أعلم يقيناً أن مناصري الجناة ومتصيدي ضحاياهم كثر، وسيعملون بجد جاهدين لإيجاد أي وسيلة لإيذاء الضحايا وإغراق المُدانين بالمدح أو تحسين صورتهم عبر تشويه صورتنا.
هنا سأستشهد بقول بريمو ليفي، وهو كيميائي وكاتب وأحد الناجين من الهولوكوست:
“إن الخلط بين الجلَّادين وبين ضحاياهم هو مرض أخلاقي أو عاطفة تجميلية للجلَّادين أو علامة شريرة على التواطؤ؛ قبل كل شيء، إنها خدمة ثمينة يتم تقديمها، بقصد أو بغير قصد، لنفي حقيقة التجارب وأحقيتها، هذه الخدمة بالفعل لا تقل دناءة عن جرائم المجرم ذاته!”.
السيدات والسادة القضاة، والمدعون العامون والمحامون الأفاضل:
بدأت عملي كصانع أفلام قبل بداية الثورة الديموقراطية في سوريا واستمريت خلالها و لطالما أُعتبرت صناعة الأفلام الوثائقية الناقدة للنظام بشكل عام جريمة لا تغتفر، ولطالما جُرِّمنا كصانعي أفلام كعاقبة على إنجاز شرائط سينمائية تحاسب وتكشف عيوب السلطات والمجتمع، وهذا يقابله دعوات لتدمير سمعتنا وثقة الناس بمحتوى شرائطنا ومنعها ومنعنا من الاستمرار بالعمل على أننا أشخاص خطيرون يجب القضاء علينا أو إذلالنا وتأديبنا.
لابد لي من الإشارة أنه خلال الفترة الماضية أجبَر النظام السوري والد أحد شخصيات فلم الكهف على الظهور بإعلامه الرسمي لإنكار محتوى الوثيقة والتحريض علينا، وكتبت المستشارة السياسية والإعلامية لبشار الأسد بثينة شعبان مقالة افتتاحية تحت عنوان “الحرب الأخطر” على أقوى صحيفة سورية لدى النظام السوري وأخرى تابعة لحزب الله وهذا مالم يحصل سابقاً! أن تحشد شخصية كبيرة لدى النظام كل شيء ضد صانع أفلام وتتهمني بأنني أدير غرفة في الغرب لفبركة الأحداث في سوريا وختمت خطابها بتحريض عالي اللهجة لتدمير سمعتي!!.
على مرِّ عملي كصانع أفلام وثائقية خلال الثورة السورية، شاهدت مايقارب ٢٥٠٠ ساعة من الرعب الذي لا يوصف وانخرطت بتصوير بعضها وصنعت شرائط احتوت على وثائق واضحة على الجرائم المستمرة التي ترتكب بحق السوريين، من استخدام غاز السَّارين والغازات المحرمة دولياً، لقتل المدنيين واستخدام الحصار والتجويع مع ضربات جوية مباشرة تستهدف متطوعي الخوذ البيضاء ومراكز عملهم، إلى المشافي ومراكز التسوق واستهداف مباشر للنشطاء، ولطالما قوبلت هذه الشرائط بحملات مضللة لا هوادة فيها من قبل النظام أو حلفائه الروس.
خطابات الإنكار والكراهية العدائية كانت جزء من جوهر نظام التعذيب وسبب مباشر لوجوده، وسبباً مباشراً للاستمرار في قتلنا أو عزلنا كصناع أفلام، رغم أن شرائطنا، وفي أغلبها، هي وثائق نضال لأجل الديموقراطية و كشف انتهاكات حقوق الإنسان والقضايا الاجتماعية والأخلاقية في مجتمع ممزق لا يرغب بالتحدث عنها، نحن فقط أفراد ملتزمون بسرد ما لا ترغب السلطات سماعه!.
أيها السيدات والسادة،
شهِدتُ على سطح الأرض وتحتها في سوريا فظاعات لا يجب السكوت عنها وما زالت تحدث! لأن النظام الذي يقف خلفها والمسؤول المباشر عنها ما زال قوياً في مكانه؛ لكن بشكل لا يمكن إغماض عيني عنه، شهِدتُ أيضاً الأفعال الجيدة التي تترك أثراً طيباً على المجتمع والتي يقف ورائها الناجون، هذه الممارسات شديدة الإيجابية هي من تهبنا معنى لا يتزعزع من التعاطف والرحمة والإيمان بالتشبث في الحياة و بأنه لا زال هناك إيمان بالجانب المضيء للبشر ويمنحنا الثقة بأننا سنجد العدالة في مكان ما على هذه الأرض.
السيدات والسادة في هيئة القضاء والادعاء العام والمحامون،
أفكر بالمحامي خليل معتوق، وأفكر بصديقي الكردي ك.أ، أفكر بزملائي صُنَّاع الأفلام الوثائقية الذين نجوا بعد الاعتقال والذين قتلوا في سبيل رواية هذه الحكاية، أفكر بزملائي المختفين قسرياً المجهولين، أصوات صراخهم، روائحهم التي لن تفارقني حتى أموت، أشباحهم التي تأتيني أثناء نومي وأثناء يقظتي، الذين منحوني معنى لأستمر في الحياة، لأكون هنا كجسد اختبر تجربة مريرة حُفِرت عميقاً في ذاكرة الجسد والوعي.
أؤمن أن لا شيء يمكنه رد الاعتبار لأجسادنا التي تم تدميرها، أو لتلك العائلات التي تبحث عن العدالة كل يوم، سوى الكشف عن مصير أحبتهم المغيبين واعتبار المؤسسات التي عذبتنا وأخفتنا كمؤسسات إجرامية إرهابية خطيرة على العالم لأنها تزيد في استمرار المأساة وتتسبب بتآكل القواعد الأخلاقية في مجتمعنا وداخل كل فرد فينا. وجدت هذه الأماكن لكسر إرادتنا كأفراد أحرار وتقويض حقنا بالشعور بفرديتنا، لتصنع منا نسخة عن النظام الذي يدمر أجسادنا، كمجموعات قلقة مثقلة بالشك، لتُغيِّب وجودنا خلف ظل الديكتاتور، حتى أنه لم يُسمح لنا أن نكون ظلالاً بل فقط أن نكون لا شيء، إلا إذا قبل أحدهم كأنور رسلان وسواه أن يكون جزءاً من هذه المؤسسات فحينها يصبح جزءاً من جسد الديكتاتور كأنور رسلان وسواه، هذه الأماكن الهمجية وأفرادها الذين يديرون وينفذون الشر فيها وجدت لأجل معاقبتنا على الوجود!.
لذلك لا بد من وجود رادع قوي لهؤلاء الأفراد الذين شكلوا مؤسسات الإبادة تلك، سيكون أول خطوات الثقة بنظام العدالة، والثقة بأن من مات تحت التعذيب لم يُنسى كأنه لم يكن، و أن العالم تغير ولم يعد مكاناً يسرح فيه الجناة بدون عقاب! غياب الرادع سيجعل المجتمع يقبل بالتعذيب ضمنياً ومعه سُتقبل كل الشرور وتظهر كل أنواع التبريرات لمن انخرطوا في هذا الشر. غياب الرادع سيكون أحد أكبر العوائق أمام بناء مجتمع معافى.
السيدات والسادة في هيئة القضاء والادعاء العام والمحامون:
جئت إلى هنا وكلي ثقة وامتنان للمحامين الذين يمثلونني في هذه القضية، وامتناناً لمحاميِّ في سوريا أنور البني و إيماناً كبيراً لا جدل فيه بجدوى هذه المحاكمة، تحمَّلت عواقب الإدلاء بتجربتي على المستوى النفسي والاجتماعي والمهني، وجئت مدعوماً بأصدقاء شاركوني التجربة في أفرع الإبادة تلك ولم يتح لهم الفرصة لمشاركة تجربتهم، محملاً بأمانة التفكير بهم دائماً. جئت الى هنا أيضاً لأجيب عن أسئلة عائلتي وابنتي الدائمة حول ما جرى قبل وأثناء وما سيجري بعد هذه المحاكمة.
اثق بحكمتكم”.